قبل أن نلاحظ غياب الدراسات الثقافية أصلا أو ندرتها، أو أنها تكون مضمرة ضمن الدراسات الاجتماعية، وهي دراسات من لزوم ما يلزم في الأوساط البحثية، وهكذا تعتبر السلطات المتعددة الدراسات الثقافية ترفاً، أو مهددة لمعطياتها الأيديولوجية التي تستبعد الثقافة أصلا، فالثقافة تكشف البُعد الديماغوجي والإقصائي لهذه المؤسسات، وللدولة المُتسلطة التي تتسربل بالأيديولوجيا القومية أو الدينية لإخفاء ماهيتها السلطوية المحض.
إن الصفة المُثلى للدراسات الثقافية، هي أن عليها أن تكون ذاتيةً تأملية، فعليها أن تتفحص نفسها نقدياً باستمرار، وبشكل خاص علاقتها مع النظام التعليمي من جهة، ومع المؤسسات الثقافية غير التعليمية من جهة أخرى.
إن هذا التأمل الذاتي ليس مسألة منهج، بمقدار ما هو ضرورة مؤسساتية.
ويأخذ هذا التأمل الذاتي روتينياً شكل فحص تاريخها الخاص، فهل الدراسات الثقافية تخصص محدد؛ أم أنها موجودة ضمن التخصصات المستقرة وخارجها؟ هل من الأفضل، على سبيل المثال، عدها ممارسة نقدية أكثر منها تخصصا؟ أسئلة كهذه ليست ثانوية في الدراسات الثقافية.
أو كما جاء في كتاب: الدراسات الثقافية: مقدمة نقدية للبحاث الأسترالي سايمون ديورنغ ترجمة د.
ممدوح يوسف عمران - عالم المعرفة - العدد 425 - يونيو 2015 - الكويت.
وفي حالنا فإن هذه الصفة المُثلي، أي الدراسة الذاتية التأملية، تجعل من المنطلقات الضعيفة، أي غياب الدراسات والإحصائيات، نقطة قوة يخصبها المخيال، حيث نستطيع سد الثغرات من جهة، وحيث نتخلص من قيود منهجية قد تشد من سبل البحث وتحبسه، والثقافة فعل الإنسان كذات مُبدعة والشارع كمتلقٍ ذاتي أيضا.
إن القفز في الخارطة السياسية العربية، والمكون الثقافي العربي عن ليبيا - من مصر إلى تونس- هو عطب في المبحث السوسيو/ ثقافي العربي، وهذا الإقصاء يحدث مع مكونات رئيسة في جسم الإقليم مع الجزائر والسودان والسعودية، رغم أن هذه البلاد تمثل عصباً رئيساً في الجغرافيا والتاريخ، بل وفي التشكيل الديموغرافي، ونجد في الغرب والعالم جملة، مكتبة كبيرة لمباحث في شؤون هذه الدول وفقراً مُقذعاً عربياً، كذلك نجد قصوراً فادحاً في المبحث العربي عن الإثنيات، المكون الديموغرافي للبلدان العربية كالأكراد والأمازيغ والطوارق والتبو وغيرهم والتي هي مشكل رئيس في المكون الثقافي لهذه البلدان.
عليه كل ما في هذه الورقة ذاتي تأملي، وشذرات ثقافية ناتجة من الشغل في الحقل ككاتبٍ وكصحفي وكناشطٍ في الفعلِ الثقافي ليس إلا.
ليبيا وهذه حقيقة، بعيدة عن الضوء، ومن هذا تسليط الضوء على وضعها الثقافي كيف كان، أمر هام ويحتاج وقتا وجهداً، لكن هنا سأكتفي بما يخص الوضع الثقافي الذي كان والذي كان له الأثر الحاسم أو المُسيطر في الراهن.
لقد نهضت ليبيا الحديثة، كما تقريبا في السودان والسعودية، ضمن حركة دينية إصلاحية، هي الحركة «السنوسية» التي مؤسسها الجزائري «محمد بن علي السنوسي» في منتصف القرن التاسع عشر، هذه الحركة المعروفة عند المؤرخين فحسب، تمكنت من صوغِ رؤيةٍ دينيةٍ تقويمية، تقوم على الاتباع من جهة، وعلى النظرة الخصوصية الإصلاحية لعلاقة الدين والحياة، لمؤسسها الذي نجح بالتمترس في الصحراء الليبية، في الابتعاد عن أي نفوذ للقوى النافذة حينها.
وبالتالي نجح حفيده، من رَأسَ الحركة - بعد وفاة والده المهدي- في تأسيس المملكة الليبية المتحدة، بعد خوض معركة جهادية تحريرية، ضد الاستعمار الفاشي الإيطالي بين العامين 1911 و1944 أي نهاية الحرب الثانية.
واستقلت ليبيا بقرار من الأمم المتحدة في ديسمبر 1951م، إنها دولة حديثة ناتجة بمعنى ما من حركة دينية إصلاحية، وتقريبا مرة ثانية كما في السودان والسعودية، ولعل هذا يحتاج للدراسة والبحث، في مجال جد هام ولم يُتطرق إليه بالدرس، بشكل موسع ودؤوب.
بين العامين 1951، و1969م تاريخ الانقلاب العسكري على الملك السنوسي، نجحَ النظامُ الملكي في إرساءِ دعائمِ دولة حديثة، هذه الدولة المُنفتحة على محيطها، وقبل ساعة إنشائها جعلت من انتمائها للجامعة العربية، تعبيرا عن رؤية المؤسسين لبعدها الثقافي العربي والديموغرافي حتى، ولذا كانت المناهج التعليمية في البدء ذات المناهج المصرية، وكذا كان جزء من المعلمين بها من المصريين في كافة المستويات التعليمية، وعلى هذا تأسست الجامعة الليبية مطلع خمسينيات القرن الماضي.
هذه الجامعة التي أنشأها المؤسسون الأوائل كما صرحٌ ثقافي، فموقعها في وسط مدينتي بنغازي وطرابلس، ومكتباتها ومحاضراتها مفتوحة لمن شاء، وأقامت مؤتمرات فكرية دولية شارك فيها أشهر المفكرين والباحثين حينها، كالمؤرخ الإنجليزي «أرنولد توينبي»، وأساتذتها من العالم والعرب كما «عبد الرحمن بدوي»، من أصدرت له الجامعة الليبية العديد من الكتب.
وفُتحت مراكز ثقافية عربية، وكانت المراكز الليبية تغص بالكتب للمؤلفين العرب الأجانب وبكل اللغات، وحتى الكتب الممنوعة في بلدانها توفرت في هذه المكتبات، كرواية «أولاد حارتنا» لنجيب محفوظ التي توفرت في الأكشاك في حينها.
لقد تكرس مفهوم وحدة الثقافة العربية، في المملكة الليبية، في التعليم وفي الحياة الثقافية، وعليه تم إنشاء المؤسسات الثقافية ولم تكن ثمة حدود، فالمسارح ساهم في إنشائها التونسيون، وكل الفنون العربية توجد في هذه المؤسسات، ومنها الفنون الشعبية لأقطار عربية عدة.
وإذا كانت الثقافة في الدولة الناشئة تُنشأُ لها مُؤسسات مُنفتحة، وإن كانت الحركة السنوسية قد ساهمت في التأسيس، فقد تأصل في الدولة بُعدها الإصلاحي ومُنطلقها كحركةٍ ثقافية، وجعل هذا من اللغة العربية كمنزلةٍ للروح، فغدت لا حدود في وجه الثقافة العربية التي ساعتها كانت في أوج نهضتها.
وتم إنشاء مكانةٍ للثقافة في المؤسسات التعليمية، فـ«أيام» طه حسين هي أيام طلبة التعليم الأساسي، وأُنشئت مؤسسات ثقافية كالمسارح ودور السينما، ونوادي الفكر وحتى النوادي الرياضية كانت من صروح الثقافة.
لكن مع هذا فإن النظام الملكي في ليبيا - كما جُلَ الأنظمة الحاكمة في حينها - كان يمنع إنشاء الأحزاب والمنظمات السياسية، بل يتم معاقبة كل من يساهم في إنشائها ولو سرا.
وكان من هذا مقتل هذا النظام، الذي فصل بين الثقافة ومؤسساتها وبين العمل السياسي، و«إن الوعي ونتائجه هما على الدوام، بأشكال مختلفة، جزء من العملية الاجتماعية نفسها» أو كما عبر عنه «ريموند ويليمز»، وهذا ما يُعبر عن أن الاستبداد والسيطرة ليسا بُعداً ثقافياً فحسب بل والأهم البعد الاجتماعي، فلم تكن الأيديولوجية الإصلاحية الدينية هي الحسم في مسألة التسلط السياسي، ولكن المسألة الاجتماعية الحسم الأبلغ، ولذا كانت ليبيا شارعاً ناصرياً، في جُهوريةٍ لانقلاب عسكري مُماثلٍ لانقلاب «جمال عبد الناصر» في مصر، و«هواري بومدين» في الجزائر.
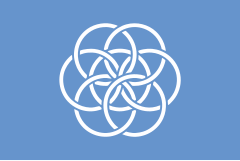
















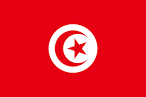
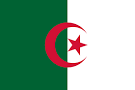


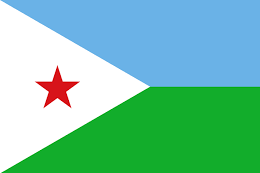
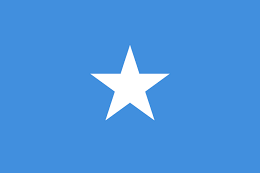
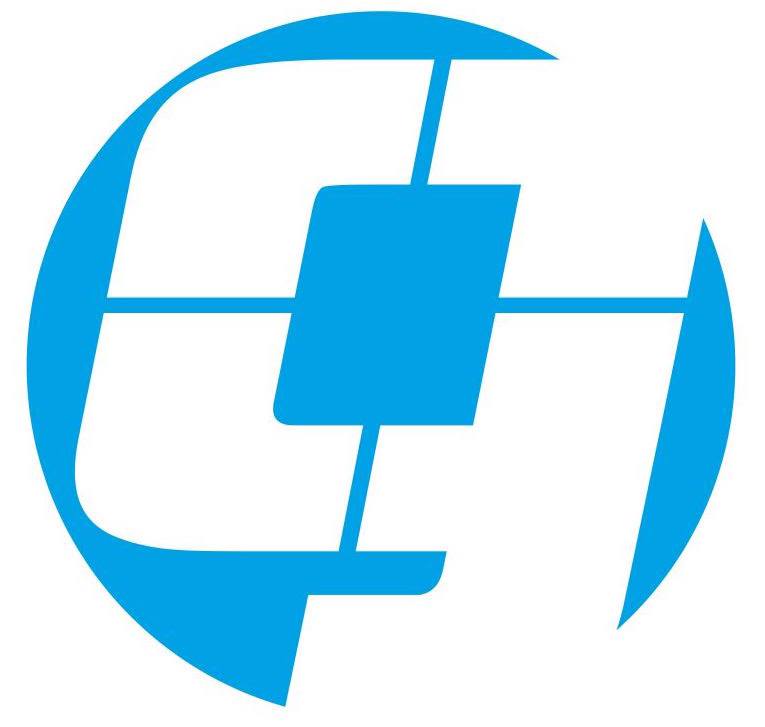







التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك