كتب الكُتّاب من كل مكان عن رحيل سيف الإسلام القذافي، وتناولته المحطات بسيلٍ من العرض والتحليل، وكلٌّ ينظر من زاويته ووفق تقييمه.
ولأن الكتابة عمّن عاصر الأحداث وواكب تسلسلها وشاهد نتائجها هي كتابة من «عين الحدث»، فإن المشهد يبدو أكثر تعقيدًا من مجرد غياب شخصية سياسية.
أُعِدَّ الرجل ليكون سليل أبيه وحامل إرث دولةٍ فُصِّلت بلا خرائط؛ فلا مؤسسات ولا إدارة بالمعنى المنهجي المتعارف عليه.
أُعِدَّ ليمسك العصا من المنتصف، فيحقق ما يريده أسياد العالم، ويستمر في الوقت ذاته في قيادة «دولة الجماهير» التي لا يعرف طلاسمها غير عقلها المُدبِّر.
فهل كان يملك من الخبرة والاحترافية ما يُمكّنه من إعادة «المتشظي» وترتيب «المبعثر»، ليُعوَّل عليه في حمل التركة آنذاك وفق ما خُطِّط له؟يرتبط سيف الإسلام مع الشعب الليبي بطيفٍ متنوع من الذكريات؛ وكان من الممكن أن يكون الرئيس الذي يخلف والده بنسبة قبول معقولة وفق معطيات ذلك الوقت، لو استمر على نهج «ليبيا الغد» وكان مخلصًا وصادقًا كما ادّعى.
ذلك المشروع الذي استقطب العقول الليبية من مختلف التخصصات ودول العالم، في تصورٍ متكامل بعيدًا عما اعتاد عليه الليبيون طوال عقود.
استبشر الناس خيرًا، وتناولت وسائل الإعلام المشروع بتفاؤل، متناسين سنوات القهر.
لكن ما غفلوا عنه هو تغيّر المنظومة العالمية آنذاك، وفكّ الارتباط بين المنظومات العربية، وبدء حقبة جديدة بمفاهيم وصُنّاع جدد.
مع سقوط النظام في الجارة تونس وبداية النهاية في ليبيا، خرج سيف الإسلام بعكس قيم «ليبيا الغد»؛ خرج مهدِّدًا ومتوعدًا، واختار الخندق ذاته مع والده دون اعتبار للمطالبين بالتغيير.
لم يخرج مساندًا للناس أو موفيًا بوعوده، بل ظهر ملوّحًا بتوزيع السلاح، وكأنه يصارع بكل جهده للتمسك بقاربه الذي تتقاذفه الأمواج.
لم يُحسن قراءة المشهد، ولم يُعوّل على الناس المعنيين بالتغيير بالدرجة الأولى، ونتيجة لموقفه وتهديداته العلنية، أصبح مطلوبًا لدى محكمة العدل الدولية، وكان ذلك أحد أكبر الأخطاء التي وقع فيها، والتي كشفت بالتالي حقيقة «ليبيا الغد».
ولأن ملاحقة «العدل الدولية» قيّدت حركته، أصبحت طرابلس والزنتان تحديدًا مقار إقامته الجبرية أو الفعلية.
ووفق المتداول، تنقّل بين مدن ليبية عدة في إطار صفقات غامضة مع خاطفيه، دون أن يعلم أحد يقينًا حقيقة نشاطاته.
ورغم كونه أحد المرشحين الذين يملكون حشودًا وأنصارًا، فإنه ظل في حكم «الوليّ المنتظر» أو «المخلّص» في نظر أتباعه، دون ردّ فعل ملموس أو تجاوب حقيقي منه أو من المقرّبين إليه.
وسط حالة انعدام الأمن، كان من الممكن الكيد له في أي لحظة خلال السنوات الماضية؛ غير أن طريقة اغتياله مؤخرًا كشفت بساطة عيشه وقلّة الرفاق من حوله.
اغتيل وحيدًا في حديقة منزله على يد متسللين، أثناء آخر اتصال له مع أحد المقرّبين، وفي غياب الحارس الذي لم يكن برفقته في تلك اللحظة.
ويبقى السؤال المعلّق: من المستفيد؟ ولماذا في هذا التوقيت تحديدًا؟ وهل كان في جعبته من أسرار الحقبة الماضية ما يهدد به عروشًا وقوى، فكان لا بد من إسدال الستار على حياته ليظل السر دفينًا معه؟لقد رحل سيف الإسلام، لكنه لم يرحل كقائدٍ يقود فيالق المحاربين، بل كظلٍّ طاردته لعنة التاريخ وتعقيدات الجغرافيا.
وبرحيله، لم تُغلق صفحة رجل فحسب، بل رُدمت بئر من أسرار والده وتاريخه الغامض.
فهل كان موته الفصل الأخير في رواية «دولة الجماهير»، أم كان القربان الضروري لولادة مخاضٍ جديد لا أحد يعرف ملامحه بعد؟ يبقى الصمت الذي لفّ لحظاته الأخيرة هو الإجابة المتاحة في وطنٍ لا يزال يبحث عن بدايته الحقيقية بين طلاسم ماضٍ لا يريد أن يمضي.
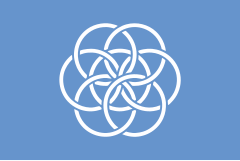
















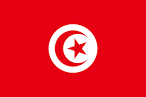
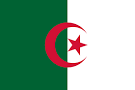


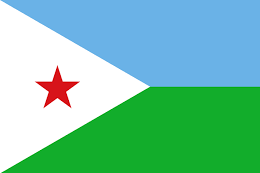
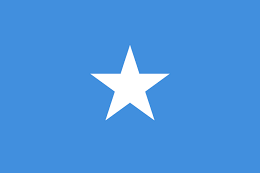
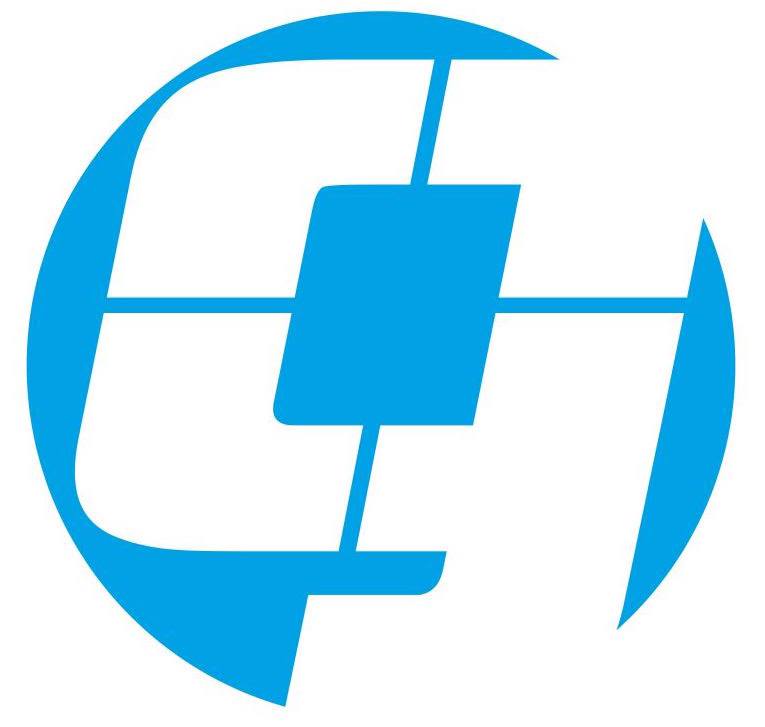







التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك