كلّنا تقطّعت أنفاسنا أمام الشاشة ونحن نتابع، في خوفٍ ووجل، اللحظات الأخيرة في حياة محكومٍ بالإعدام، وخطواته الثقيلة نحو المقصلة.
لكنّنا لا نعرف إطلاقاً شعور المحكوم عليه بالإعدام منذ أكثر من عامَين، ورأسه لا يزال بين كتفيه، ومع ذلك ينتظر النهاية التي لن يتابعها أحد، في أيّ لحظة.
لفتني ما كتبه أحدهم على حائطه في" فيسبوك" عن أمنيته الأخيرة قبل أن يموت، أن يرى العالم خارج أسوار غزّة.
كنت أتابع هذا الشخص منذ بداية الحرب، واكتشفت أنّه قد تغيّر على نحوٍ كبير؛ فبعد أن كان شخصاً يائساً يبحث عن مأوى ولقمة، أصبح فيلسوفاً بمعنى الكلمة، لأنّه استطاع أن يخرج من مأساته بالحكمة، وبدأ يطرح أسئلة يعجز كبار المفكّرين عن الإجابة عنها.
وكأنّه استسلم لحاله في الخيمة مع أطفاله، وقرّر أن ينظر إلى ما وراء السياج، ويحلم، ويطرح أسئلته حول العالم المجهول خلف الحدود، وهو الذي لم يخرج من قطاع غزة طيلة حياته، بل إنّه من الذين وُلدوا وترعرعوا في أحد أحياء غزّة القديمة، إذ ينغلق الناس هناك على أنفسهم وعاداتهم وتقاليدهم وأفكارهم ومعتقداتهم المسلَّم بها جيلاً بعد جيل.
وهكذا لم يعرف خارج حدود الحيّ الكبير القديم سوى وسط القطاع الذي نزح إليه مُرغماً، حيث بؤس مخيّم اللاجئين، وساحل البحر الذي أصبح شاطئه مطرّزاً بخيام النازحين البائسين.
تساءل ذلك البائس عن العالم خارج غزّة، وطرح سؤالاً غريباً: هل يستيقظ الناس خارج هذه الحدود الشائكة على صوتٍ غير صراخ الأطفال، وهم يتزاحمون بعيونٍ يملؤها القذى حول صهريج الماء، ويتدافعون من أجل الظفر بدورٍ متقدم أمامه، ليعودوا إلى أمهاتهم في الخيام بالماء الذي ستُغسل به بعض الأطباق والملابس، ويُبقى بعضه ليُغسل به صغارهم بعد قضاء حاجتهم خلف الخيمة؟ هكذا طرح هذا البائس سؤاله الصعب، وكان الأصعب عليّ أن أخبره بالحقيقة المريرة، لذلك أكملت قراءة باقي أسئلته التي طرحها على نفسه، فيما كان يصارع سرباً من البعوض تجمع فوق رأسه، وكأنّه يريد أن يمتصّ الأفكار اللعينة قبل أن تقتله لفرط إلحاحها عليه.
وتساءل ذلك البائس عن أول عملٍ يفكر به الناس خلف الحدود، وقال إنّه قد سمع أنّ الناس تستيقظ من نومها، بعيداً عن هذا الموت اليومي، فتفكر في شرب القهوة من يد زوجة محبة، ومداعبة الأطفال الدافئين في أسرّتهم.
لكنه يؤكد أنّه، بالقطع، لم يسمع أنّ الناس هناك قد تستيقظ وهي تفكر في الانتحار، مثلما يحدُث معه كلّ صباح.
ستقتلك الأسئلة التي يطرحها الرجل، الفقير إلّا من تخيلاته حول عالمٍ يتمنى لو عاش فيه قبل أن يموت.
وهو يتساءل فعلاً إن كان الناس يرقصون ويتعانقون بعيداً عن مقبرة الأحياء التي يخطو فوقها بتثاقل كل يوم؛ إذ يرقص الناس هنا فوق جثث بعضهم، فيما يقنعون أنفسهم أنهم يسرقون لحظات سعادة، والحقيقة أنهم كاذبون حتّى الثمالة، مصابون بمرضٍ عضال اسمه الوهم.
فلا يمكن أن ينبت الورد في المقبرة، ولا يمكن أن تتحوّل الأرض التي يركض فوقها منذ وُلد إلى حلبة سباقٍ يصل فيها إلى الأمام؛ لأنه، فعليّاً، يلهث ويجري ويتراجع إلى الخلف، فيبكي، ويتحول بكاؤه هذا إلى هوية.
قاتلةٌ حقّاً أسئلة ذلك البائس، الذي توقف عن البحث عن طعام لأطفاله، واكتفى بأن يرسل أكبرهم إلى ما يُعرف بـ" التكية"، ليصطف في طابور غير منتظم، ويعود بطعامٍ رديء يسقط في بطونهم انتظاراً لموتٍ لا يجيء، لكنه يدوّي في سقوطه مع أسئلةٍ عجيبة أخرى: عن أناسٍ يفتحون النوافذ فلا يتناثر الموت في وجوههم بسبب قصف الصواريخ، أو لا يلفّهم الصمت المريع المنبئ بكارثة، كما يشعر هو في كل لحظة.
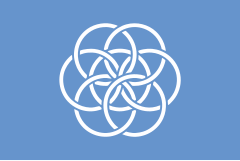
















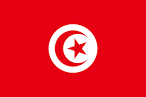
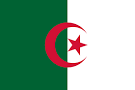


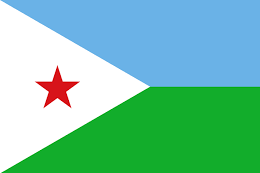
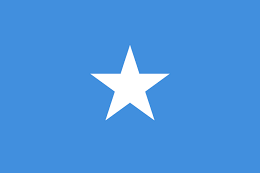








التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك