منذ استقلال الجزائر، ظل سلوكها الإقليمي، ولا سيما تجاه المغرب، يثير تساؤلات متكررة؛ فبدلا من أن يشكل البلَدَان رافعة للتكامل المغاربي، اتسمت علاقتهما بتوتر مزمن: حدود مغلقة، أزمات دبلوماسية متواترة، صراعات غير مباشرة، وغياب شبه تام لأي أفق تعاون مستقر.
مع مرور العقود، بدا “سوء الجوار” هذا وكأنه معطى ثابت، لا مجرد نتيجة خيارات سياسية ظرفية؛ غير أن اختزال هذا السلوك في السياسة اليومية أو في الخلافات الدبلوماسية يظل قاصرا، إذ يفرض فهم هذا المسار طرح سؤال أعمق: هل يتعلق الأمر بسلسلة من القرارات الظرفية، أم ببنية دولة تشكلت في شروط تاريخية جعلت علاقتها بجوارها محكومة بمنطق مختلف عن منطق التعاون الطبيعي؟ينطلق هذا المقال من فرضية تفسيرية مفادها أن سلوك الجزائر الخارجي لا يمكن فصله عن شروط تأسيس الدولة ذاتها، وعن طبيعة الكيان السياسي الذي نشأ في سياق استعماري خاص.
يظهر التاريخ السياسي المقارن أن الدول لا تتكون بالطريقة نفسها، ولا تحمل جميعها الشروط ذاتها للاستقرار؛ فبين دول نشأت كخلاصة لمسار تاريخي طويل من التراكم الاجتماعي والمؤسسي، ودول تشكلت دفعة واحدة في سياقات استثنائية، تتباين درجات التماسك والقدرة على الاستمرار.
لا يرتبط هذا التباين بحداثة الاستقلال في حد ذاتها، ولا بقوة الدولة الظاهرة؛ بل بكيفية تشكل المجال السياسي ذاته: هل سبق المجتمع الدولة، أم فرض الإطار السياسي على مجتمع لم يكتمل اندماجه بعد؟ في هذا الفارق التأسيسي تكمن جذور هشاشة بعض الدول التي تبدو مكتملة في شكلها؛ لكنها تظل قلقة في عمقها التاريخي.
في هذا الإطار، تبرز الحالة الجزائرية بوصفها حالة دالة على دولة نشأت قبل أن يكتمل تشكل مجتمعها السياسي داخل إطار ترابي موحد؛ فالجزائر المعاصرة، رغم ما تمتلكه من جهاز إداري ومؤسسات سيادية، تحمل في بنيتها آثار نشأة، لم تكن حصيلة مسار داخلي طويل، بل نتيجة إعادة تركيب خارجية فرضت الخريطة قبل أن تستبطن اجتماعيا.
من هنا، لا يمكن فهم إشكالية الاستقرار في الجزائر إلا بالعودة إلى سؤال التأسيس نفسه: كيف تشكل هذا الكيان؟ وعلى أية قاعدة تاريخية واجتماعية تم بناؤه؟لتوضيح هذا المنظور، يفيد استحضار تجربتي ألمانيا وإيطاليا، باعتبارهما حالتين كاشفتين للفارق البنيوي بين دولة جاء توحيدها السياسي تتويجا لمسار اجتماعي طويل وبين دولة فرضت كإطار سياسي قبل اكتمال تشكل مجتمعها التاريخي.
المقارنة هنا ليست بحثا عن نموذج يحتذى؛ بل أداة تحليلية لإبراز اختلاف مسارات التكوين وحدود القياس بينها.
لقد توحدت إيطاليا سنة 1861 بعد مسار طويل من تشكل فضاء لغوي وثقافي مشترك، ومن تفاعل اقتصادي ومؤسسي بين مدن وإمارات وكيانات محلية، سبقته قرون من التاريخ الاجتماعي المتراكم.
وعلى الرغم من الانقسام السياسي الذي طبع شبه الجزيرة الإيطالية خلال العصور الوسطى والحديثة، فإن المجتمع الإيطالي كان قد تبلور تاريخيا قبل لحظة التوحيد، وكانت الروابط الثقافية واللغوية والاقتصادية أسبق من الدولة المركزية.
أما ألمانيا، فقد تحقق توحيدها السياسي سنة 1871 عقب سلسلة من الحروب والصراعات قادتها قوى محلية داخل مجال يمتلك هوية لغوية وثقافية متقاربة، وبنى اقتصادية ومؤسساتية، سبقت الإعلان السياسي، فقد ولدت الدولة الألمانية الموحدة من رحم فضاء اجتماعي متشكل، عرف مسارا طويلا من التنظيم الاقتصادي والإداري داخل الكيانات الجرمانية، قبل أن تتوج هذه السيرورة بإعلان الإمبراطورية.
في هاتين الحالتين، لم تنشأ الدولة من عدم، ولم تفرض خريطة سياسية على مجتمع غير منسجم؛ بل جاء التوحيد خاتمة لمسار تاريخي طويل: سبق المجتمع الدولة، وسبقت الذاكرة الخريطة.
يسمح هذا التمييز بتفادي الخلط بين الدولة المتأخرة التوحيد وبين الدولة المصنوعة استعماريا؛ فالأولى حديثة سياسيا، لكنها قديمة اجتماعيا وتاريخيا.
أما الثانية فهي حديثة في الشكل؛ لكنها مقطوعة الجذور تاريخيا، إذ تسبق فيها الدولة المجتمع، وترسم الحدود قبل أن تستبطن اجتماعيا.
من هذا المنطلق، يمكن مقاربة الحالة الجزائرية بوصفها نموذجا مكثفا للدولة المصنوعة استعماريا، لا من زاوية الحكم القيمي، أو السجال السياسي، بل من زاوية التاريخ البنيوي وتكون الدولة.
قبل سنة 1516، كان المجال المغاربي الغربي مجالا سياسيا مفتوحا تتحكم فيه سلالات مغربية متعاقبة وشبكات تجارية ودينية عابرة للصحراء.
ومع دخول العثمانيين إلى الجزائر سنة 1516 وتشكل إيالة الجزائر، لم تنشأ دولة ترابية حديثة بالمعنى الأوروبي؛ بل كيان بحري ساحلي محدود الامتداد، ظل نفوذه الفعلي محصورا في المدن الساحلية وبعض المحاور القريبة منها، دون سيطرة متصلة على الداخل ولا على الصحراء.
وظلت الهضاب العليا والفضاءات الصحراوية تدار وفق منطق قبلي وروحي وتجاري، وترتبط عبر الزوايا ومسارات القوافل بفضاءات سياسية أخرى أكثر مما ترتبط بسلطة الجزائر الساحلية.
عند سنة 1830، حين نزلت القوات الفرنسية في سيدي فرج واحتلت مدينة الجزائر، لم تكن قد أسقطت دولة وطنية موحدة ذات حدود مضبوطة؛ بل سيطرت على عاصمة إيالة عثمانية ضعيفة البنية الترابية.
وما تلا ذلك لم يكن احتلالا عابرا، بل عملية بناء دولة من الصفر.
فبين 1830 و1847، جرى حسم الجزء الأكبر من السيطرة على الداخل؛ بينما استمر تأمين المجال والهوامش والحدود الصحراوية تدريجيا خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر.
بذلك، كان توحيد المجال، الذي سيسمى لاحقا الجزائر، نتاج قوة استعمارية خارجية، لا نتيجة مسار داخلي طويل شبيه بما عرفته ألمانيا أو إيطاليا؛ غير أن التحول الأعمق وقع مع إعادة رسم المجال الترابي ذاته، فمنذ مطلع القرن العشرين، وضمن مشروع إمبراطوري يهدف إلى بناء الجزائر الكبرى وربط شمال إفريقيا بعمقها الإفريقي، اعتمدت الإدارة الفرنسية ترتيبات إدارية متعاقبة، من بينها تنظيم Territoires du Sud (1902)، ألحقت بموجبها مساحات صحراوية شاسعة بالجزائر الاستعمارية.
في هذا السياق، يبرز مثال الصحراء الشرقية المغربية بوصفه كاشفا لطبيعة هذا التأسيس، إذ كانت مناطق بشار وتندوف ومساراتها القبلية تابعة للدولة المغربية عبر روابط البيعة والمرجعية الدينية والقضائية ومرتبطة بشبكات تجارة وقوافل عابرة للصحراء؛ غير أن فرض الحماية على المغرب سنة 1912 مكن فرنسا من إعادة تركيب المجال دون اعتبار للامتدادات التاريخية، ففصلت هذه المناطق وألحقتها إداريا بالجزائر الفرنسية بين 1912 و1934.
عند استقلال المغرب سنة 1956 ثم استقلال الجزائر سنة 1962، لم تعد هذه الحدود إلى النقاش التاريخي؛ بل جرى تثبيتها وفق مبدأ الحدود الموروثة عن الاستعمار (uti possidetis juris).
هنا، نشأت مفارقة تأسيسية عميقة: دولة جزائرية مستقلة ورثت كامل المجال الذي رسمه الاستعمار الفرنسي، بما في ذلك مجالات لم تكن يوما جزءا من تاريخها السياسي قبل 1830، بينما وجدت دول الجوار نفسها أمام حدود لا تعكس الامتدادات التاريخية السابقة.
وقد عبرت حرب الرمال سنة 1963 عن هذا التناقض في أول تجل عسكري وسياسي له.
إلى جانب هذا التأسيس الترابي الخارجي، تبرز مسألة عدم التجانس الداخلي بوصفها عاملا بنيويا مضاعفا للهشاشة، لا من زاوية التنوع الثقافي العام؛ بل من زاوية اختلاف الأصول السياسية والتاريخية للمكونات المجمعة داخل الدولة.
المجال الجزائري الحديث يضم مجتمعات ذات مسارات تاريخية متباينة: مجتمعات واحاتية؛ مثل مزاب ذات تقاليد حكم ذاتي وتنظيم ديني خاص، وقبائل منطقة القبائل التي تشكلت تاريخيا كشعب قائم بذاته بأنماط تنظيم مستقلة عن الدولة المركزية، ومجالات صحراوية جنوبية ارتبطت تاريخيا بفضاءات سياسية أخرى في الساحل الإفريقي، بما في ذلك امتدادات أزوادية لم تتشكل أصلا داخل أفق الدولة الجزائرية.
لا يعني هذا التباين مجرد اختلاف ثقافي؛ بل يعكس تجميع مجتمعات ذات مرجعيات سياسية متباعدة داخل دولة واحدة، قبل اكتمال عملية صهر تاريخي طويلة؛ ما جعل الوحدة تقوم على الضبط الإداري والأمني أكثر مما تقوم على تفاعل سياسي تراكمي ينتج شعورا اندماجيا مستقرا.
يزداد هذا التعقيد حدة إذا استحضر البعد الجغرافي الصحراوي، فالمجال الصحراوي يشكل قرابة ثمانين في المئة من التراب الجزائري، وهو مجال شاسع ضعيف الكثافة السكانية، ذو تاريخ اجتماعي واقتصادي مختلف جذريا عن الشمال.
لم يكن هذا الامتداد الهائل نتاج توسع تاريخي تدريجي لدولة قائمة؛ بل نتيجة قرار استعماري، فتحولت الصحراء داخل الدولة الوطنية إلى مجال ذي وظيفة أمنية واستراتيجية بالدرجة الأولى، لا إلى فضاء مندمج في البنية الاجتماعية والسياسية العامة.
يقود هذا النمط من التأسيس إلى نتيجة بنيوية أعمق، مفادها أن الدولة التي تتشكل بوصفها نتاجا لإرادة خارجية، لا كتتويج لمسار اجتماعي داخلي، تميل إلى حمل وظيفة تتجاوز المجتمع الذي تحكمه، الدولة المصنوعة استعماريا لا تبنى ابتداء لخدمة ديناميات داخلية نابعة من حاجات المجتمع؛ بل لتأدية أدوار محددة ضمن منظومة أوسع صاغتها القوة التي أنشأتها.
يقارب هذا الوضع، في الأدبيات السياسية، مفهوم الدولة الوظيفية (Functional State).
في هذا السياق، يصبح السلوك الخارجي لهذه الدولة، وعلاقتها بجوارها الإقليمي، جزءا من بنيتها الوظيفية، لا مجرد خيار دبلوماسي عابر.
فالتوتر الدائم، والاستقطاب، وإدامة النزاعات، تقرأ هنا بوصفها آليات تضمن بقاء الدولة في موقعها الوظيفي، وتؤجل باستمرار لحظة التحول إلى دولة سيادية مكتملة الاندماج في محيطها الطبيعي.
يضاف إلى هذه المحددات البنيوية عامل اقتصادي ـ سياسي بالغ الأهمية، يتمثل في طبيعة الدولة الريعية.
لقد مكّنت الريوع النفطية والغازية الدولة الجزائرية، منذ سبعينيات القرن الماضي، من تعويض جزء من هشاشتها البنيوية عبر آلية شراء الزمن السياسي، لا عبر بناء اندماج اجتماعي منتج.
الريع وفّر للدولة قدرة ظرفية على الحفاظ على التماسك، وامتصاص التوترات، وتأجيل الاستحقاقات الإصلاحية العميقة؛ لكنه في المقابل حال دون تشكل عقد اجتماعي قائم على الجباية والمساءلة والإنتاج.
وبهذا المعنى، لم تنجح الجزائر في الإفلات من منطق “لعنة الموارد”(Resource Curse)، حيث تتحول الثروة الطبيعية من رافعة لبناء الدولة إلى بديل عن بنائها.
إن الدولة الريعية قد تبدو مستقرة في المدى القصير، وقادرة على الاستمرار الشكلي؛ لكنها تظل بنيويا دولة مؤجلة المستقبل، لأن تماسكها مرتبط بتقلبات السوق العالمية، لا بصلابة مؤسساتها أو باندماج مجتمعها السياسي.
غير أن هشاشة الدولة الجزائرية لا تقتصر على مشكل النشأة المصطنعة وعدم التجانس المجتمعي؛ بل تتجلى كذلك في أزمة الحكم والشرعية والهوية السياسية منذ الاستقلال.
فقد عجزت الدولة عن الانتقال من شرعية ثورية ظرفية إلى شرعية سياسية مؤسساتية مستقرة.
وتحولت الثورة، بدل أن تكون لحظة تأسيس تفتح بعدها مرحلة بناء الدولة المدنية، إلى مرجع شرعي دائم يستدعى باستمرار لتبرير السلطة، لا لضعف قيمتها الرمزية، بل لغياب سند دولتي تاريخي سابق عليها.
في تحليل الشرعية، كما يبين ماكس فيبر (Max Weber)، لا يكفي احتكار العنف المشروع (Monopoly of the Legitimate Use of Force) لقيام الدولة المستقرة، ما لم يكن هذا الاحتكار مؤسسا على شرعية معترف بها ومتجذرة في الوعي الجماعي.
الدولة المصنوعة استعماريا تمتلك شرعية قانونية ومؤسساتية واعترافا دوليا؛ لكنها تفتقر إلى الشرعية التاريخية المتراكمة، فتضطر إلى تضخيم الشرعية الكاريزمية (Charismatic Legitimacy) بوصفها تعويضا دائما، في الحالة الجزائرية، أسهم هذا الخلل في تعطيل الانتقال نحو شرعية قانونية عقلانية مستقرة.
في هذا السياق، يبرز الدور المركزي للمؤسسة العسكرية، فمنذ 1962، لم تتبلور في الجزائر علاقة واضحة بين السلطة المدنية والسلطة العسكرية؛ بل ظلت الأخيرة الفاعل الحاسم في إنتاج الحكم وضبط المجال السياسي.
وقد استمدت هذه المكانة من شرعية المشاركة في حرب التحرير، ثم تحولت تدريجيا إلى قاعدة دائمة لممارسة السلطة؛ ما حال دون تشكل تداول مدني طبيعي، وأبقى الدولة في نمط حكم تدار فيه السياسة بواجهة مؤسساتية، بينما تحسم القرارات الجوهرية داخل بنية عسكرية أمنية.
من زاوية علم الاجتماع السياسي، يوضح تشارلز تيلي (Charles Tilly) أن الدولة الحديثة هي حصيلة صراعات داخلية طويلة، أنتجت توحيد المجال، وبناء جهاز إداري وجبائي، وإخضاع القوى المحلية (State Formation).
في ألمانيا وإيطاليا، كان هذا الصراع داخليا وقادته قوى محلية داخل مجتمع متشكل، وانتهى بتفوق السلطة المدنية.
أما في الحالة الجزائرية، فقد أنجز هذا المسار بالنيابة عبر القوة الاستعمارية، فكانت النتيجة دولة ذات جهاز قوي؛ لكن بعلاقة خارجية بالمجتمع، علاقة إدارة وضبط أكثر منها علاقة تمثيل عضوي.
ويبرز المنهج التاريخي البنيوي، كما عند فرناند بروديل (Fernand Braudel)، أن الدول تقاس بزمنها الطويل، لا بتاريخ استقلالها.
فالجزائر الحديثة تفتقر إلى المدى الطويل الدولتي السابق على القرن التاسع عشر، وتعتمد بدلا من ذلك على ذاكرة سياسية مصنعة بعد الاستقلال، تشمل تقديس الخريطة الاستعمارية وتحويل وحدة التراب، رغم عدم تجانسه التاريخي والبشري، إلى مسألة وجودية غير قابلة للنقاش.
هنا يبرز البعد الرمزي بوصفه نتيجة مباشرة لهذه البنية التاريخية، فالاحتماء المستمر بالثورة والشهداء لا يقرأ فقط كوفاء للذاكرة؛ بل كآلية دفاع جماعي (Collective Defense Mechanism) تعوض هشاشة الشرعية المؤسساتية.
ومع تعثر الحاضر، يعاد الاستثمار في الماضي، ويجري تضخيم عدد الشهداء بوصفه طوطما سياسيا (Political Totem) ومقدسا مدنيا، حيث تتحول الذاكرة من مجال تاريخي قابل للفحص والنقاش إلى منطقة محرمة، ويغدو الاقتراب من الأرقام أو مساءلة السرديات فعلا يعامل بوصفه مساسا بالكينونة السياسية ذاتها.
ومن منظور علم النفس السياسي (Political Psychology)، يقود هذا الوضع إلى نمط من الهستيريا الجماعية (Collective Hysteria)، حيث يخلق كيانا متخيلا أكبر من الواقع، وتنتج نبرة خطابية هجومية تدعي القوة والبطولة؛ بينما تخفي شعورا مزمنا بالهشاشة والقلق السيادي.
يتجلى ذلك في نرجسية جماعية (Collective Narcissism) تقوم على تمجيد الذات، ورفض النقد، وإسقاط الإخفاقات على الخارج، فيغدو الجوار مرآة إسقاطية (Projective Mirror)، ويصبح الصراع ضرورة رمزية بقدر ما هو خيار سياسي.
إن هذا التحليل لا يحمل حكما أخلاقيا ولا نبوءة آنية بالانهيار، بل توصيفا لبنية دولة متشكلة إداريا، لكنها معلقة تاريخيا ورمزيا.
يعلمنا التاريخ، حين يقرأ ببرودة الأكاديمي لا بحرارة السياسي، أن التناقضات البنيوية المؤجلة لا تلغى بالشعارات الوهمية، بل تتراكم في صمت، إلى أن تفرض، عاجلا أو آجلا، لحظة إعادة تركيب كبرى.
والأيام بيننا.
أستاذ علم السياسة بجامعة القاضي عياض.
مدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء.
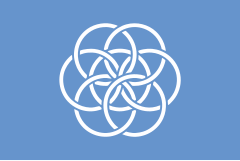
















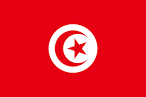
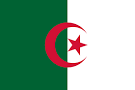


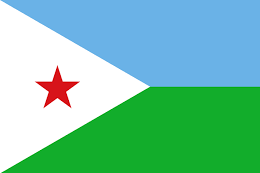
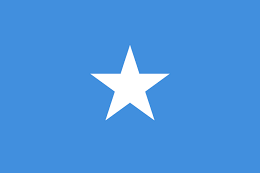








التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك