كل ماهو جديد فى عالم الاكتشافات العلمية والابتكارات الحديثة والفضائيات نلتقى فى هذا المقال.
**** الثلاجة قد تفسد الأدوية!
نصائح لحفظ الأدوية بأمان.
أفاد الدكتور أليكسي بانوف الأستاذ المشارك بالجامعة التقنية الروسية، أن الاعتقاد السائد بأن الثلاجة هي المكان الأمثل والأكثر أمانا لتخزين الأدوية المنزلية هو اعتقاد خاطئ تماما.
وأوضح قائلا: “بالنسبة لعدد من الأدوية، فإن التبريد، وخاصة التجميد، لا يحسن من تخزينها، بل قد يؤدي إلى فقدان خصائصها العلاجية، وتكوين نواتج تحلل خطرة.
لذلك تحدد شروط تخزين كل دواء على حدة من قبل الشركة المنتجة، وتُذكر في تعليمات الاستخدام”.
وأضاف أن الخطر الرئيسي للثلاجة، إلى جانب احتمال التجميد، يكمن في الجمع بين انخفاض درجة الحرارة وارتفاع الرطوبة.
فبعض أشكال الجرعات مثل الأقراص، المساحيق، الكبسولات، وبعض المراهم، حساسة للغاية للرطوبة، وعند تخزينها في ظروف غير مناسبة مثل حجرة الثلاجة العادية دون وعاء محكم الإغلاق، قد تتعرض للرطوبة، ما يؤدي إلى تغيرات في خصائصها الفيزيائية والكيميائية، وتلف المكونات الفعالة، بالإضافة إلى خطر نمو الميكروبات.
وينطبق هذا بشكل خاص على المستحضرات العشبية والمنتجات المصنوعة من مكونات طبيعية.
وأشار الدكتور بانوف إلى أن هناك أدوية لا يجب تجميدها أبدا، بما في ذلك معظم اللقاحات، والأنسولين، وبعض أنواع الإنترفيرون، وغيرها من الأدوية البروتينية.
وقال: “المكونات الفعالة في هذه الأدوية، مثل البروتينات والدهون، عرضة للتلف عند درجات الحرارة تحت الصفر.
وهذا التغير غير القابل للعكس في التركيب الجزيئي يجعل الدواء عديم الفائدة، وفي حالة اللقاحات، يفقد الدواء خصائصه المناعية.
كما قد يؤدي التجميد إلى انفصال غير قابل للعكس للمستحلبات أو تلف الأمبولات.
وحتى لو بدا الدواء طبيعيًا بعد إذابته، فإن فعاليته غير مضمونة، ما يجعل استخدامه غير آمن”.
وأضاف أن الأدوية على شكل شراب أو معلقات مائية لا ينبغي حفظها في الثلاجة إلا إذا نصت التعليمات على خلاف ذلك، موضحا: “غالبا ما تؤدي درجات الحرارة المنخفضة إلى تبلور وترسب السكريات والمكونات الأخرى، ما يجعل تحديد الجرعة بدقة أمرا مستحيلا.
وقد تصبح المستخلصات السائلة والصبغات عكرة وتتغير خصائصها.
كذلك، لا ينبغي حفظ الأدوية بالقرب من الأطعمة ذات الروائح النفاذة أو الرطوبة مثل الخضراوات والفواكه والأسماك، لأن ذلك يؤثر سلبا على جودتها”.
وختم الدكتور بانوف بالقول: “إذا نصت تعليمات استخدام الدواء على حفظه في الثلاجة، فيجب وضعه في وعاء منفصل محكم الإغلاق على الرف الأوسط، بعيدا عن المجمد والباب، حيث تحدث أكبر تقلبات في درجات الحرارة”.
*** اكتشاف 20 ألف قطعة نقدية فضية خلال ترميم قصر في موسكو.
عُثر خلال أعمال ترميم قصر تاريخي في كورنيش بيرسنييفسكايا بوسط موسكو على كنز ثمين يضم نحو 20 ألف قطعة نقدية فضية.
وكانت القطع النقدية الفضية مخبأة داخل إناء فخاري في الطابق الثاني من غرف سكن التاجر أفيركي كيريلوف.
وأعلنت وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا عن هذا الاكتشاف على قناتها في “تليغرام”، واصفة الكنز بأنه أحد أهم الاكتشافات في السنوات الأخيرة.
كان أفيركي كيريلوف تاجرا بارزا ورجل دولة في موسكو خلال القرن السابع عشر، وامتلك قصرا فخما بُني في النصف الثاني من القرن نفسه، يُعد اليوم معلما معماريا هاما.
وكان التجار من مرتبته يؤدون وظائف رئيسية في العلاقات الاقتصادية، كوسيط بين منتجي السلع المحليين والتجار الأجانب والدولة.
اشتغل كيريلوف بتجارة الملح، وترأس ديوان الخزينة الكبرى، وجمع الضرائب من التجار.
وقد أبهر قصره معاصريه بواجهته الفاخرة وفناءه المُعتنى به وغرفه المزينة بثراء.
قُتل التاجر على يد أفراد فرقة من الرماة المتمردين في 16 مايو 1682، بسبب ما وُصف بأنه “أخذ رشاوى كبيرة وفرض ضرائب متنوعة وارتكب أعمالا غير عادلة”، رغم عدم وجود دلائل وثائقية تثبت الرشوة.
التأريخ الأولي وتفاصيل الاكتشاف.
وتعود القطع النقدية، وفقا للتأريخ الأولي، إلى نهاية القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر، وهي فترة شهدت اضطرابات سياسية عميقة في روسيا، تمثل المرحلة الختامية لحكم سلالة روريك وبداية ما يُعرف بـ”الزمن المظلم”.
في تلك الحقبة، لم تكن الفضة وسيلة للدفع فحسب، بل كانت أيضا وسيلة ادخار موثوقة عند اهتزاز الثقة بالسلطات والإصلاحات النقدية.
يتعامل العلماء بحذر مع فرضيات مالك الكنز، وهناك عدة سيناريوهات مطروحة، منها أن تكون هذه القطع جزءا من مدخرات كيريلوف الشخصية، أو رأس مال جماعي للمجتمع التجاري، أو أموالا مخصصة للتجارة أو دفع الضرائب.
وأكدت وزارة الثقافة أن الكنز سيُوثّق ويُدرس بدقة، وسيُحافظ عليه لأغراض علمية.
وسيحدد الخبراء العدد الدقيق للقطع النقدية، وتكوين الكنز، وقيمته باستخدام أساليب حديثة في الترميم والتحليل.
**** المرحلة الأكثر إرهاقا في الحياة.
كشف فريق من العلماء عن مرحلة في الحياة تتسم بأعلى مستويات الإرهاق الجسدي والعقلي.
وأوضح فريق البحث أن مرحلة الأربعينيات من العمر هي أكثر مراحل حياتنا إرهاقا، حيث أشارت البروفيسورة ميشيل سبير، عالمة التشريح بجامعة بريستول، إلى أن ذلك لا يعود إلى التقدم في السن فقط، بل إلى تزامن تغييرات بيولوجية طفيفة مع ذروة متطلبات الحياة والعمل وتربية الأبناء.
وقالت سبير: “إرهاق منتصف العمر يُفهم على أنه عدم توافق بين القدرات البيولوجية ومتطلبات الحياة.
أجسامنا لا تزال قادرة على إنتاج الطاقة، لكنها تفعل ذلك في ظروف مختلفة عن بداية مرحلة البلوغ، بينما غالبا ما تبلغ متطلبات الطاقة ذروتها”.
وفي العشرينات من العمر، يكون الجسم أكثر تسامحا بيولوجيا: استعادة العضلات أسرع، والاستجابات الالتهابية قصيرة، وإنتاج الطاقة على المستوى الخلوي فعال.
وتزود الميتوكوندريا، وهي مصانع الطاقة داخل الخلايا، الجسم بطاقة كبيرة مع تقليل الفاقد ونواتج الالتهاب، ما يجعل قلة النوم أو ممارسة الرياضة المكثفة أقل عبئا على الجسم.
ما الذي يتغير مع دخول الأربعينيات؟مع التقدم في العمر، تبدأ تغييرات طفيفة بتقويض هذا النظام الدقيق:
انخفاض كتلة العضلات: ابتداء من أواخر الثلاثينيات، تقل كتلة العضلات إذا لم تحافظ عليها تمارين القوة، ما يجعل الأنشطة اليومية تتطلب طاقة أكبر.
انخفاض كفاءة الميتوكوندريا: تستمر في إنتاج الطاقة، لكنها أقل كفاءة، ما يؤدي إلى شعور أكبر بالتعب وزيادة الفضلات الخلوية.
تراجع جودة النوم: تصبح أنظمة تنظيم النوم أقل استقرارا، ويصبح النوم أخف وأكثر اضطرابا بسبب التغيرات الهرمونية وزيادة مستويات الكورتيزول ليلا.
زيادة الإجهاد العقلي: تتحمل الأفراد أعباء معرفية وعاطفية كبيرة في منتصف العمر نتيجة تعدد المهام والعمل والرعاية الأسرية، ما يزيد الإرهاق حتى بدون جهد بدني كبير.
وعلى الرغم من هذه الصعوبات، تشير سبير إلى أن مستويات الطاقة تبدأ بالتحسن مع دخول الستينيات، رغم انخفاض القدرة البدنية:
يقل التوتر، ويصبح العمل أقل إرهاقا.
تتحسن أنماط النوم، ويصبح أكثر انتظاما.
تتكيف الميتوكوندريا بشكل مذهل، ويمكن تعزيز كفاءتها عبر تمارين رفع الأثقال المنتظمة، ما يساعد على استعادة القوة وتحسين الصحة الأيضية ورفع مستويات الطاقة.
وتقول سبير: “الهدف ليس استعادة طاقة العشرينيات، بل حماية الجسم وإعطاء الأولوية للتعافي، عبر انتظام النوم وممارسة تمارين المقاومة وإدارة التوتر والتغذية الكافية، خاصة البروتين”.
***تمرين دماغي واحد يحد من خطر الخرف بنسبة 25%.
أظهرت دراسة حديثة أن ممارسة تمرين بسيط واحد لتدريب الدماغ يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى 25%، رغم تحذيرات باحثين مستقلين من المبالغة في تفسير هذه النتائج.
وتعد الدراسة تجربة عشوائية مضبوطة – المعيار الذهبي للبحوث الطبية – وبدأت بتسجيل أكثر من 2800 مشارك، أعمارهم 65 عاما فأكثر، في أواخر التسعينيات.
وتم توزيع المشاركين عشوائيا على أربعة مجموعات: تدريب السرعة، والذاكرة، والاستدلال، ومجموعة ضابطة لم تخضع لأي تدريب.
وخضع المشاركون لجلسات تدريبية لمدة ساعة مرتين أسبوعيا لمدة خمسة أسابيع، تلتها أربع جلسات داعمة بعد عام وثلاثة أعوام، ليصل إجمالي ساعات التدريب إلى أقل من 24 ساعة.
وأوضحت مارلين ألبرت، الباحثة المشاركة من جامعة جونز هوبكنز بالولايات المتحدة، أن التدريب على السرعة كان دائما “مفيدا بشكل ملحوظ”.
وبعد عقدين من الزمن، أظهرت سجلات برنامج الرعاية الصحية الحكومي (Medicare) أن المشاركين في هذا التدريب انخفض لديهم خطر الإصابة بالخرف بنسبة 25%.
أما النوعان الآخران من التدريب، الذاكرة والاستدلال، فلم يسجلا فرقا ذا دلالة إحصائية.
وأكدت ألبرت أن الدراسة تعطي لأول مرة فكرة واضحة حول ما يمكن فعله لتقليل خطر الإصابة بالخرف.
تمرين السرعة وتأثيره على الدماغ.
يتضمن تمرين السرعة النقر على السيارات وإشارات المرور التي تظهر في مناطق مختلفة على شاشة الكمبيوتر.
وأوضحت ألبرت أن الباحثين لا يعرفون بعد سبب فعالية هذا التمرين تحديدا، لكنه قد يؤثر على “الترابط في الدماغ”.
وأكدت أن فهم الآلية الدقيقة قد يساعد في تطوير تمارين جديدة أكثر فعالية في المستقبل.
وأشارت إلى أن النتائج تنطبق فقط على هذا التمرين المحدد، ولا يمكن تعميمها على ألعاب تدريب الدماغ الأخرى.
ومع ذلك، حذّرت راشيل ريتشاردسون، الباحثة في مؤسسة كوكرين، من أن “على الرغم من الدلالة الإحصائية، إلا أن النتيجة قد لا تكون مثيرة للإعجاب”، مشيرة إلى أن هامش الخطأ يتراوح بين انخفاض بنسبة 41% وانخفاض بنسبة 5% فقط.
وأضافت أن استبعاد الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في البصر أو السمع قد يجعل نتائج الدراسة غير ممثلة لجميع السكان.
وأكد باتيست لورينت، خبير الإحصاء الطبي في جامعة كوليدج لندن، أن الدراسة “تعاني من قيود جوهرية”، موضحا أن النتائج، رغم دلالتها في إحدى المجموعات الفرعية، لا تُعتبر دليلا كافيا على فعالية التدخل.
وأشار إلى أن هناك حاجة لمزيد من البحث لتحديد ما إذا كان التدريب المعرفي يمكن أن يقلل بشكل مؤكد من خطر الإصابة بالخرف.
نشرت الدراسة في مجلة “ألزهايمر والخرف: البحوث الانتقالية والسريرية”.
***علماء: مناعة الخفافيش ستساعد في الاستعداد لمواجهة العدوى الجديدة.
اكتشف علماء جامعة دون التقنية أن البكتيريا التي تعيش في أمعاء الخفاش الليلي الشائع (Nyctalus noctula) تستطيع إفراز مواد فعالة بيولوجيا ذات خصائص مختلفة تبعا للموسم وحالة الخفاش.
ويقول أليكسي إرماكوف، مدير معهد الأنظمة الحية في الجامعة: “اتضح أن البكتيريا الموجودة في أمعاء خفافيش Nyctalus noctula التي تدخل في سبات شتوي تنتج بنشاط أكبر مواد تحمي خيوط الحمض النووي من التلف، مثل التقطع.
وهذا يعني أن الكائنات الدقيقة ساعدت خلايا الحيوانات، خلال فترة السبات، على تجنب تلف مادتها الوراثية”.
وتضيف أولغا كوندراتينكو، أخصائية علم الأحياء الدقيقة الطبية، رئيسة قسم علم الأحياء الدقيقة الطبية والمناعة في جامعة سامارا الطبية، بلا شك هذه النتائج قيمة للرعاية الصحية العملية.
ويمكن أن تساهم هذه الدراسات في فهمنا للآليات المناعية والميكروبيولوجية الكامنة وراء حمل مسببات الأمراض دون ظهور أعراض في الحيوانات، بالإضافة إلى العوامل التي تحدد انتشار هذه العدوى بين البشر.
وتقول: “تعتبر الخفافيش خزانات طبيعية وناقلات لمجموعة واسعة من العدوى البكتيرية والفيروسية.
وتشمل هذه العدوى أمراضا خطيرة مثل داء الكلب، والحمى النزفية التي يسببها فيروسا إيبولا وماربورغ، فضلا عن العدوى المرتبطة بفيروس نيباه وعدد من مسببات الأمراض الأخرى”.
ووفقا للمفاهيم الوبائية الحديثة، غالبية الأمراض المعدية الناشئة ستكون مرتبطة بالفيروسات.
لذلك، يبقى احتمال ظهور أوبئة جديدة من هذا النوع مرتفعا، ما يؤكد الحاجة إلى المراقبة المستمرة والبحوث الأساسية في هذا المجال.
***إحياء معادلة عمرها 100 عام يحل لغز الهواء الذي نتنفسه.
توصل باحثون إلى طريقة جديدة تتيح التنبؤ بحركة الجسيمات النانوية غير منتظمة الشكل خلال الهواء، وهي فئة رئيسية من ملوثات الهواء التي ظلت تحديا كبيرا أمام النمذجة الدقيقة لعقود.
وتُعد هذه الطريقة الأولى من نوعها، إذ تجمع بين البساطة والقدرة التنبؤية العالية، ما يسمح للعلماء بحساب سلوك الجسيمات المحمولة جوا دون الحاجة إلى افتراضات رياضية معقدة أو نماذج تجريبية مسبقة.
ويستنشق الإنسان يوميا ملايين الجسيمات المجهرية مثل السخام والغبار وحبوب اللقاح واللدائن الدقيقة والفيروسات، إضافة إلى الجسيمات النانوية المصنعة.
ويمكن لبعض هذه الجسيمات الدقيقة جدا أن تخترق عمق الرئتين وتصل إلى مجرى الدم، حيث يرتبط التعرض المزمن لها بزيادة خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية والسرطان.
ورغم أن معظم الجسيمات العالقة في الهواء لا تتمتع بأشكال كروية منتظمة، فإن النماذج الرياضية التقليدية كانت تفترض كرويتها لتسهيل الحسابات، ما حدّ من دقة التنبؤ بحركتها وسلوكها الحقيقي في الهواء، وخاصة الجسيمات غير المنتظمة التي قد تشكل خطرا صحيا أكبر.
وجاءت أهمية النموذج الجديد الذي طوره فريق من جامعة ووريك البريطانية في سد فجوة علمية طويلة الأمد في مجال الهباء الجوي، حيث تمكن لأول مرة من توصيف حركة الجسيمات غير الكروية بدقة أعلى، وهي الفئة التي تمثل الغالبية العظمى من ملوثات الهواء.
وأوضح قائد الفريق البحثي، البروفيسور دونكان لوكيربي، أن الهدف كان تطوير نموذج قادر على التنبؤ بحركة الجسيمات بمختلف أشكالها، لما لذلك من دور أساسي في تحسين نماذج تلوث الهواء، وفهم انتشار الأمراض المحمولة جوا، ودراسة التفاعلات الكيميائية في الغلاف الجوي.
واعتمد الباحثون في اكتشافهم على إعادة صياغة وتعميم ما يعرف بـ”عامل تصحيح كونينغهام”، وهو مفهوم رياضي يعود إلى أوائل القرن العشرين، حيث جرى توسيعه ليصبح قابلا للتطبيق على الجسيمات بمختلف أشكالها، وليس الكروية فقط.
ويشير لوكيربي إلى أن هذا التعميم أعاد إحياء الفكرة الأصلية للنموذج الرياضي، وسمح بإجراء تنبؤات دقيقة دون الحاجة إلى محاكاة معقدة أو معايرة تجريبية.
وتستند الطريقة الجديدة إلى استخدام ما يسمى بـ”موتر التصحيح”، وهو أداة رياضية تحاكي قوى السحب والمقاومة التي تؤثر على الجسيمات أثناء حركتها في الهواء بغض النظر عن شكلها، مع ميزة أساسية تتمثل في عدم الحاجة إلى بيانات تجريبية مسبقة.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التطور في تحسين أنظمة رصد جودة الهواء، وتعزيز فهم انتقال الأمراض عبر الهواء، وتطوير أدوية استنشاقية أكثر كفاءة، إضافة إلى تطبيقات واسعة في مجالات الصحة البيئية والمناخ والتقنيات النانوية.
نشرت الدراسة في مجلة Journal of Fluid Mechanics Rapids.
*** اكتشاف بقايا عظمية لكائن برمائي غامض في جنوب روسيا يعيد إحياء صلة محتملة بين العلم والأسطورة.
في أحضان الطبيعة الخصبة بإقليم كراسنودار جنوب روسيا، حيث تختزن الأرض تاريخا سحيقا، عثر الباحثون على اكتشاف حفري لافت تمثل في شظايا عديدة من هياكل عظمية تعود إلى كائن برمائي غامض.
ويحمل هذا الكائن في تكوينه أحد أسرار التطور، وربما مفتاحا لفهم أصل إحدى الأساطير القديمة التي تناقلتها الشعوب عبر الأجيال.
وقد أعلن معهد “بوريسياك” الروسي لعلم المتحجرات عن هذا الاكتشاف، الذي يُعد نافذة نادرة على عالم البليوسين المتأخر قبل نحو 3.
0–3.
3 ملايين سنة.
فقد عُثر قرب مدينة بيلوريتشينسك على بقايا ذلك الكائن محفوظة بين الطبقات الرسوبية، كرسالة زمنية دقيقة تروي قصة جنس منقرض يُعرف باسم “ميوبروتيس ويزي”، والذي يُعد أقدم وأكثر أسلاف البرمائيات الذيلية المعروفة باسم البروتيات اكتمالا حتى الآن.
وتضم الشظايا المكتشفة أجزاء دقيقة من الجماجم وعناصر متعظمة من الجهاز اللامي، وهي ليست مجرد عظام متحجرة، بل مادة تشريحية فريدة مكّنت العلماء لأول مرة من وصف بنية جمجمة هذا الكائن بدقة وإعادة بناء ملامحه الغامضة.
وقد كشفت الدراسة عن مخلوق مائي كبير الحجم يختلف عن نظيره المعاصر، البروتيس الأوروبي، بجمجمة أعرض وأكثر ضخامة، وخطم قوي، وفكين شديدي البنية، إضافة إلى عينين متطورتين يُرجّح أنهما كانتا تراقبان بيئة مائية راكدة أو بطيئة الجريان.
إذ يرجّح الباحثون أن هذه الكائنات القديمة، بحجمها اللافت وهيئتها المميزة، قد شكّلت النموذج الطبيعي الذي ألهم الحكايات الشعبية القديمة عن تنين “الأولم”، ذلك الكائن الأسطوري الذي استقر في الذاكرة الجمعية لقرون طويلة.
فالبشر، عبر التاريخ، غالبا ما حوّلوا كائنات حقيقية إلى أساطير، مضيفين إليها الغموض والمبالغة والقوة الخارقة.
ولا يسلط هذا الاكتشاف الضوء على فصيلة منقرضة فحسب، بل ينسج رابطا عميقا بين الذاكرة الجيولوجية للأرض والذاكرة الثقافية للإنسان.
فهو يذكّر بأن الأساطير قد تكون أصداء بعيدة لواقع طبيعي اندثر، وأن كل عظمة متحجرة تحمل قصة، وكل جمجمة قد تكون أصل حكاية.
ويشير تركيب الجمجمة، بما في ذلك غياب تطور بعض العظام الأنفية والجبهية، إلى كائن محافظ في مساره التطوري، حافظ على تصميم بدائي ناجح يتلاءم مع بيئة المياه الهادئة.
كما أن أسنانه، رغم قلة عددها، كانت أكبر وأكثر تنوعا في الشكل، ما يوحي بنظام غذائي ونمط حياة مميزين في ذلك العالم المائي القديم.
وهكذا، لا يُسجَّل هذا الاكتشاف بوصفه خبرا علميا فحسب، بل كقصيدة تطورية نقشتها الطبيعة على صخور الزمن، تنتظر من يفك رموزها ليكمل فصلا جديدا من سفر الحياة على كوكب الأرض، حيث لا تكون الحفريات مجرد بقايا، بل جسورا بين العوالم.
***فرنسا تنزل إلى المياه سفينة عسكرية من جيل جديد.
شهد حوض “PIRIOU” الفرنسي لبناء السفن مؤخرا احتفالية خصصت لإنزال أول سفينة عسكرية من نوع Patrouilleur Hauturier إلى المياه، تم تطويرها لصالح سلاح البحرية في البلاد.
وأشار موقع Naval News إلى أن المديرية العامة للتسليح التابعة للجيش الفرنسي كانت قد وقعت عام 2023 عقودا للحصول على سبع سفن جديدة من فئة Patrouilleur Hauturier، وبدأ العمل على تصنيع أول سفينة منها في مايو 2024، وأنزلت على المياه مؤخرا، ومن المفترض أن تدخل الخدمة لصالح الأسطول الفرنسي في أبريل 2027.
يبلغ طول كل سفينة من السفن الجديدة 92 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 2400 طن، ما يجعلها أكبر من سفن الدوريات العسكرية المستخدمة من قبل الجيش الفرنسي حاليا، كما يمكن لهذه السفن الإبحار بسرعة 21 عقدة بحرية، وقطع 6000 ميل بحري في كل مهمة، والعمل في مهمات تستمر لـ30 يوما بعد التزود بالمؤن والوقود.
حصلت هذه السفن على رادارات Thales NS54 4D AESA، وأجهزة سونار متطورة، وسلّحت بمدافع من عيار 40 ملم، وأنظمة دفاع جوي قصيرة المدى من نوع “SIMBAD”، وأنظمة دفاعية مضادة للدرونات، وصممت لتخدم في سلاح البحرية لمدة 35 سنة.
وتنص الخطط الدفاعية للجيش الفرنسي للفترة 2024-2030 على طلب ثلاث سفن إضافية من فئة Patrouilleur Hauturier، مما يرفع العدد الإجمالي إلى عشرة سفن، ومن المتوقع أن تدخل آخرها الخدمة بحلول عام 2035.
****العلماء يكتشفون شكلا جديدا من الحياة القديمة في أعماق جبال المغرب.
عثر فريق بحثي على أحافير ميكروبية غريبة في أعماق جبال المغرب، دفعتهم إلى إعادة التفكير في أماكن البحث عن أقدم علامات الحياة على كوكبنا.
وعثرت الفريق بقيادة الباحثة روان مارتيندايل من جامعة تكساس على أحافير ذات سطح مجعد يشبه التموجات، محفورة في صخور رملية في سلسلة جبال الأطلس بالمغرب.
وما أثار الدهشة هو أن هذه الصخور تكونت قبل 180 مليون سنة على عمق 180 مترا على الأقل تحت سطح البحر، نتيجة انهيارات أرضية عنيفة في أعماق المحيط.
ويعد هذا الاكتشاف غريبا، لأن البصمات المماثلة المعروفة للعلماء هي لـ “حصائر ميكروبية ضوئية” – وهي مجموعات بكتيرية تعيش في المياه الضحلة حيث يصلها ضوء الشمس لصنع غذائها.
وبعد التحليل، توصل الفريق إلى استنتاجين مذهلين:
هذه المستعمرات الميكروبية لم تكن تعتمد على الضوء، لأن الظلام كان دامسا في ذلك العمق.
عمر هذه البصمات أقل من 540 مليون سنة، ويعود سبب حفظها بهذه الجودة إلى أن الحياة الحيوانية كانت نادرة في ذلك العصر السحيق، ما يعني أن هذه الآثار الدقيقة لم تتعرض للتلف أو الإتلاف الذي تسببه الكائنات الأكثر تعقيدا.
ويعتقد الفريق إلى أن هذه الميكروبات القديمة كانت “كيميائية التخليق”، أي أنها استمدت طاقتها من التفاعلات الكيميائية، مثل تحليل مركبات الكبريت أو الميثان، وليس من التمثيل الضوئي (من الشمس).
وربما ازدهرت هذه الكائنات في دورات مرتبطة بالكوارث الطبيعية، حيث كانت الانهيارات الأرضية تجر معها كميات من المواد العضوية من المناطق الضحلة إلى الأعماق، وعند تحللها، وفرت “وجبات” كيميائية لهذه الميكروبات.
وفي الفترات الهادئة بين الانهيارات، كانت الميكروبات تنمو وتشكل طبقات رقيقة على القاع، ثم يحفظ أثرها أحيانا عندما يدفنها انهيار مفاجئ بطبقة من الرواسب.
ويعد هذا الاكتشاف تحولا مهما في فهمنا للحياة المبكرة، إذ يقترح أن البيئات العميقة والمظلمة وغير المستقرة ربما كانت موطنا لأشكال حية بدائية، وليس فقط المياه الضحلة الهادئة.
وهذا يفتح آفاقا جديدة للبحث عن أقدم آثار للحياة على الأرض، وربما حتى على كواكب أخرى، حيث قد تكون مثل هذه البيئات العميقة قد وفرت ملاذا لحياة بدائية.
كما يؤكد أن آثار الحياة لا تقتصر على بيئات معينة، بل يمكن العثور عليها في أماكن لم يكن العلماء يتوقعونها سابقا.
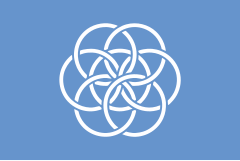
















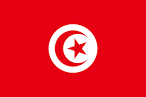
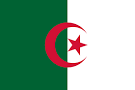


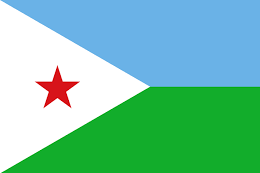
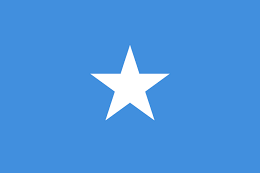








التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك