بعد 14عاماً من الغياب، عبرت الحدود إلى سورية، نحو 20 يوماً كانت قد مضت على التحرير، لكن الزمن بدا وكأنه يتدفق نحوي دفعة واحدة.
كانت الرحلة عبر بيروت ومعبر المصنع، لحظات لا تُنسى، وأنا وزملائي في التلفزيون العربي نترقب الوصول إلى نقطة العبور السورية لنرى علم الثورة، ونستنشق هواء الوطن.
شبان سوريون عشرينيون، كان بعضهم ملثماً.
اقتربنا بالسيارة منهم، وكنت أصورهم وتبادلنا السلام، فقلت لأحدهم لماذا تغطي وجهك؟ النظام سقط، مم تخاف؟ انزع هذا اللثام.
كانوا ثلاثة شبان، أكبرهم ربما عمره 22 عاماً، نزعوا اللثام وأنا أصوّرهم، ابتسموا بخجل قائلين: نحن لا نخاف.
وللأمانة، كنتُ المتوتّرة، من السلاح الذي يحملونه واللثام والأجواء التي أحاول استكشافها.
كان شعوراً مختلطاً بين الفرح والتوجس والاطمئنان والرغبة بالبكاء.
قلتُ في سرّي: هؤلاء شبان صغار جداً، كم من الأسى رأوا وعاشوا؟أخيراً، ظهرتُ على الشاشة من دمشق أول مرة في حياتي، قدّمتُ لشهر برنامج" حوارات دمشق" على التلفزيون العربي، الجميع يدلي بدلوه، شخصيات ومسؤولون من السلطة أو الإدارة الجديدة كما سُمّيت حينها، يجلسون على طاولة واحدة مع أقصى يسار المعارضين لهم سلفاً (قبل أن يروا خيرهم من شرهم ولهم أسبابهم)، ووجوه تحاول التعرّف بعضها إلى بعض، بعد زمن طويل من الانقطاع، يستكشفون ويحاولون سبر أغوار المشهد السوريالي في سورية حينها.
" سوريا لكل السوريين" اللافتة التي تستقبلك عند الدوار الرئيسي لمدينة إدلب، عبارة، وإن بدت بسيطة، لكنها في بلد عاش طويلاً معنى الإقصاء، كانت تشبه وعداً أكثر مما تشبه جملة ترحيب عادية.
حظيتُ باستقبال فاجأني، أصدقاء عرفتهم عن بُعد سنوات وعرفوني عبر الشاشة، قالوا لي: كنتِ صوتنا، أجبتهم بأنهم هم الأساس، وأن من ناضل على الأرض هو الأجدر بكل تقدير، كان كلامهم مؤثراً، وحمّلني مسؤولية إضافية.
كانت حينها بداية العودة السورية من المنافي، والناس يلتقون بعضهم بعضاً.
لفتتني حينها فوقية بعضهم، وإن كنتم تذكرون، انتشرت جملة" حكم سورية ليس كحكم إدلب".
هناك من بدأ يستخدمها بطريقة فجة بالنسبة لي.
استشعرت محاولة تصغير غير مباشرة، كان لافتاً، وأحياناً مستفزّاً، ذلك الأسلوب الفوقي لدى بعضهم، بالحديث مع من لم يتسنَّ لهم الوقت لنفض غبار الحرب عن ملابسهم.
كنت حاضرة وأرى وأراقب ردّات الفعل، " الجماعة القادمة من إدلب"، كما حصرها بعضهم، تتعامل مع طريقة الحديث هذه بمنتهى الرقي والاحترام، حتى أن أحدهم قال لي: بصراحة، تحدّثنا، بعض الشباب وأنا، مع الشيخ (الرئيس أحمد الشرع) إن مهمتنا انتهت، ولا نريد أن نكون عبئاً، وليأتِ غيرُنا من هم أخبر منا لهذه المرحلة.
شهر في بداية التحرير قابلت فيه، بحكم عملي، كل مستويات القادمين لإدارة سورية الجديدة، عسكريين، مسؤولين إعلاميين وإداريين ونشطاء وسياسيين، وخُضنا في كل النقاشات السهلة والصعبة.
الانطباع العام الذي وصل إليّ عنهم أنهم، أولاً، محترمون وهادئون جداً ويحاولون أن يرسلوا رسائل تطمين بطريقة غير مباشرة، من خلال حديثهم واستخدامهم للمفردات بعناية.
ولكي أفهم أكثر، كان لا بد من زيارة إدلب، بدعوة من صديق، ذهبنا أنا وزوجي الصحافي هُمام البني وابنتي، للتعرّف إلى عائلته في إدلب، وكانت الرحلة من دمشق إلى حمص مسقط رأسه، تلتها زيارة إلى مسقط رأسي مدينتي الجميلة الوادعة السلمية.
ومررنا بقرى وبلداتٍ دمّرها الأسد، لا شيء إلا الركام، ومررنا أيضاً بمناطق جديدة كلياً، بنيت في السنوات الخمس الأخيرة.
" سوريا لكل السوريين" اللافتة التي تستقبلك عند الدوار الرئيسي لمدينة إدلب، عبارة، وإن بدت بسيطة، لكنها في بلد عاش طويلاً معنى الإقصاء، كانت تشبه وعداً أكثر مما تشبه جملة ترحيب عادية.
مررْنا ببعض المحلات، واشتريتُ فناجين قهوة وبعض الهدايا، أناس لطيفون مرحّبون (بعدها بعدة أشهر، إنْ تذكرون، بدأ حديث عن نساء منهن صحافيات يضعن الحجاب فقط عند زيارتهن إدلب.
استغربت ذلك الحديث، فقد تجولت فيها ودخلت محلاتها ومطاعمها بلباسي الطبيعي المعتاد، ومن دون حجاب، ولم أشعر لحظة بأي جو رافض أو مستهجن".
كان يوماً جميلاً لنا في إدلب باستضافة عائلة صديقنا أبو الفيصل الكريمة.
عند العاشرة ليلاً وأنا أضع أول لقيمة طعام بفمي، وردني اتصال بموافقة وزير الدفاع مرهف أبو قصرة على مقابلة تلفزيونية معي على التلفزيون العربي في اليوم التالي العاشرة صباحاً.
كان أبو الفيصل لم ير عائلته وأولاده منذ بداية" ردع العدوان"، يعني منذ شهرين تقريباً أو ربما أكثر، فقلت له: يا أبو الفيصل، يجب أن نشد الرحال الليلة إلى دمشق لنصل في الصباح (المسافة ست ساعات) هل هناك تاكسي يوصلنا؟ فضحك وقال: تاكسي شو يا بنت الحلال.
أنا أوصلكم إلى الشام.
كان" كفو"، لم ير عائلته إلا ساعتين، وعاد معنا إلى دمشق من أجل مقابلتي مع الوزير.
بعدما وصلنا بخير وسلامة، علمتُ لماذا ضحك أبو الفيصل عندما سألته عن تاكسي يوصلنا من إدلب إلى دمشق، فالطريق كان خطراً، خصوصاً ليلاً.
وكانت هناك كمائن لفلول النظام، ومررنا من إحدى البلدات التي لم تُمشَّط بشكل كامل، وكان أبو الفيصل يعطي إحداثيات مسيرنا كل ساعة تقريباً للرفاق، ليتمكنوا من الوصول إلينا إذا تعرّضنا لأي خطر.
أصدقكم القول، لو كنت أعلم ذلك كله لما تحرّكنا خطوة خارج إدلب بعد منتصف الليل.
بعدها، كانت المحطة التالية طرطوس، المدينة الساحلية الجميلة الهادئة.
ذهبنا برفقة مجموعة ممن أصبحوا أصدقاء أعزاء.
كانت الجولة نهاراً، وحواجز الأمن العام على الطريق تستوقفنا بكل احترام، وتسأل من نحن وإلى أين نذهب، وكان أبو أحمد قائد الرحلة والسيارة أيضاً شوماخر سورية حرفياً، كان حالف يمين أنه لن يرفع قدمه عن دعسة البنزين حتى نصل إلى طرطوس.
وربما وصل، منذ تلك اللحظات، رهاب السرعة لدي إلى أقصاه.
جلسنا في مطعم على البحر، اعتادوا زيارته لطيب طعامه ودماثة صاحبه في الاستقبال كما قالوا.
وتعمّد صديقنا التعريف بطائفة صاحب المطعم وزيادة كيل المديح له على حسن استقباله وطيبة نفسه.
ومرّر هذه المعلومة بهدوء، وكأنه أراد إيصال رسالة تطمين.
كان المطعم شبه فارغ، فالناس لم تستكن بعد للوضع الجديد.
قال أحد الأصدقاء: أتمانعون إن دعوت صبية صديقتنا للغداء معنا؟
قلنا: لا طبعاً.
أهلاً وسهلاً.
جاءت سيدة طرطوسية جميلة لطيفة، وجلست معنا وتحدثنا عن كيفية تنظيم العمل مرة أخرى بعد سقوط النظام في بعض المؤسسات، وغير هذا من شؤون.
في مكان ويوم آخر.
جلسة غير رسمية (off the record كما يُقال)، مع أحد القيادات العسكرية.
طرحتُ مسألة المخاوف المتعلقة بالأجنحة المتشدّدة والفصائل والسلاح المنفلت وقوتها والقدرة على احتوائها (كان هذا في أول شهر من التحرير).
كان هناك اعتراف بحديثه بحساسية هذه المسألة.
وفي الوقت نفسه، طَرحَ رؤيتهم تجاه آلية ضبطها التي لن أخوض في تفاصيلها وتعقيداتها، لأنها ما زالت في طوْر التنفيذ، ولكن بيت القصيد كان حينها.
أنهم نعم، هم يدركون كل المخاطر ونتشارك معهم الهواجس نفسها، نحن، على الصفحة نفسها، من الصفحات الكثيرة لهذا الكتاب المتشعب صعب القراءة.
ناك تحدّيات يعرفونها، تحدّياتهم هم أنفسهم وتحولاتهم ومحيطهم، وتحدّيات بلد دمرته الحرب بالكامل بحجره وبشره حرفياً وليس مجازياً.
ميكافيللي كان حاضراً في بداية التحرير.
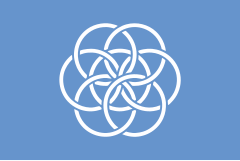
















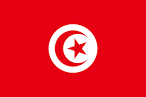
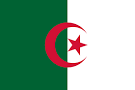


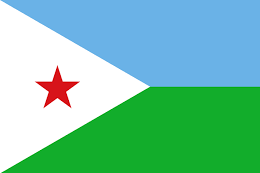
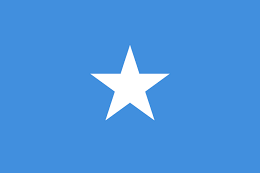








التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك